شِعْر/ مروان ياسين الدليمي
1 : (الدرس الأول في الخيبة )
لم يكن في نيّتي أن أصبح جنديًا.
كان المسرح كل ما أعرفه،
أو على الأقل، كل ما أردت أن أتعرف عليه.
دخلت كلية الفنون
وأنا أحمل على ظهري حقيبة ممتلئة بالأسئلة،
وأحلامًا لا صوت لها ،
تنتظر من يمنحها دورًا في نصٍ ما،
على خشبة ما.
أربع سنوات أمضيتها بين النظريات،
أسماء المخرجين، صراع المدارس، حوارات لم تُكتب بعد.
كنت أقرأ المسرح كما لو أنه وسيلة لفهم العالم، لا لتمثيله فقط.
كنت شغوفًا،
ليس بالشهرة، بل بشيء يشبه الحقيقة.
الفن بدا، وقتها، الطريق الوحيد إليها.
لكني لم أكن أعلم أن ثمة طرقًا أخرى،
أسرع،
وأكثر قسوة،
توصلك إلى الحقيقة نفسها، لكن بثمن لا يُحتمل.
لم يكن هناك إنذار.
في آخر سنة،
في اللحظة التي بدأتُ فيها أضع ملامح مشروعي الأول،
وصَل الأمر: استدعاء للجيش.
كانت الحرب قد بدأت بين العراق وإيران،
وكنت من بين آلاف آخرين،
سُحبوا من دفاتر مشاريعهم إلى خنادق الموت.
لم يكن هناك وقت للتفكير.
بين ليلة وضحاها، كنت على الحدود.
لا خشبة.
لا أضواء.
لا جمهور.
فقط طين، وبنادق، وأوامر لا تحمل سوى الصمت.
هناك،
اكتشفت
أن الإنسان يمكن أن يتحول إلى سطر غير مكتمل في رواية لم يكتبها أحد.
أن الحياة، رغم ما يُقال، لا تملك خطّة بديلة.
كان ذلك درسي الأول في الخيبة.
الحرب لا تكتب مذكراتها، لكنها تكتبك.
وفي كل يوم هناك،
كنت أُحذَفُ من الجملة التي كنت أظن أنها حياتي.
لم تعد الأحلام شيئًا يمكن أن يُنسج.
كل شظية كانت تمزقُ منها جزءًا،
وكل انفجار كان يعيد تشكيل المعنى، لا بل ينفيه تمامًا.
سبع سنوات.
أن تقول “سبع سنوات” أمر،
وأن تعيشها… شيء آخر تمامًا.
ثلاث مرات أنقذني شيء لا أعرف اسمه.
بعضهم يسميه القدر.
بعضهم يسميه الحظ.
بعضهم يسميه الله .
لا أعرف.
فقط أعلم أني خرجت من هناك حيًا، لكن ليس كما دخلت.
عندما عدت، لم أكن أحمل حقيبة.
لم أكن أملك حتى صوتًا داخليًا واضحًا.
كانت الحرب قد أخذت كل شيء:
اندفاعي،
يقيني،
وهشاشة الأمل التي كنت أعيش عليها.
كل ما بقي كان الصمت.
2: (على المسرح الخطأ )
أقول لنفسي أحيانًا:
ربما لم تكن خنادق الحرب سوى مسرح بلا كواليس.
خشبة مائلة،
وأضواء مكسورة،
ونصّ كتبه الجنون،
يُعاد تمثيله كل يوم.
لم يكن أحدنا بطلاً.
لم نكن شخصيات.
كنا مجرد أجساد تتبادل المواقع مع الموت.
حين وصلت إلى الجبهة، لم يكن في ذهني شيء.
لم يكن هناك متّسع لأي شيء.
ما قرأته من دراما،
ما درّسته عن الفعل والصراع والعقدة،
بدا فجأة تافهًا،
غريبًا،
بلا جدوى.
هنا،
كل شيء يُحَلّ بالدم.
كل مشهد يُعاد، ولا أحد يصفّق في النهاية.
السماء كانت رمادية،
ترمش بالقذائف لا بالنجوم.
الأرض ناعمة ومبللة،
لكنها لا تحتضنك.
الريح تحمل الغبار لا الرسائل.
والوقت ،
كان مجرد لعبة رقمية تتكرر فيها الخسارة بلا حفظ تلقائي.
كانوا يسألون: مَن يعيش ؟
والإجابة الوحيدة كانت: من لم يمت بعد.
لا أسماء، لا حكايات.
فقط أصوات تتبعثر مع الانفجار،
وجثث تُجرُّ مثل أكياس ممتلئة بالوحل،
دون أن يسأل أحد عن تفاصيلها.
في تلك السنين،
لم أفكّر بالفن.
لم أفكر بالكتابة.
فقط كنت أعدّ الأيام كما يعدّ السجين المسامير في الجدار.
لا لتصنع شيئًا منها،
بل لتُذكِّر نفسك بأنك ما زلت موجودًا.
ثلاث مرات اقترب الموت مني بشكل مباشر.
مرة انفجرت قذيفة خلفي مباشرة،
وموجة الهواء رمتني كما يُرمى حجر في بحيرة ساكنة.
مرة أخرى، توقّف زميلي في المشي ليربط رباط حذائه.
الخمس ثوانٍ التي تأخر فيها أنقذتني.
القذيفة سقطت حيث كنت سأقف بالضبط.
أما الثالثة،
فكانت في اليوم الذي دخلتُ فيه إلى بيتٍ ظننته خاليًا.
كنت أبحث عن كسرة خبز ،
وحين دفعت الباب بكتفي،
انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة خلف الستارة.
الزجاج اخترق الجدار،
لكن جسدي ظل واقفًا عند العتبة.
كأنَّ الباب صدّ عني الموت،
أو أن الخبز الذي لم أجده
هو ما دلّني على الطريق دون أن أعرف.
في كل مرة، كنت أخرج حيًا،
لكنني أفقد شيئًا من نفسي لا أستطيع تسميته.
هناك … على المسرح الخطأ،
أدركت شيئًا واحدًا:
أن أكثر العروض تراجيدية هي التي لا جمهور لها.
ولما انتهت الحرب،
لم يكن هناك تصفيق.
لم يكن هناك ستارة تُسدل.
خرجنا كما نخرج من حلم طويل،
مشوّش،
متعب،
ولا نعرف إن كنا نائمين أم مستيقظين.
خرجت من الجيش ولم أكن أملك شيئًا.
حتى الحلم،
الذي حملته ذات يوم مثل ورقة قبول جامعي،
كان قد تمزق بالكامل.




















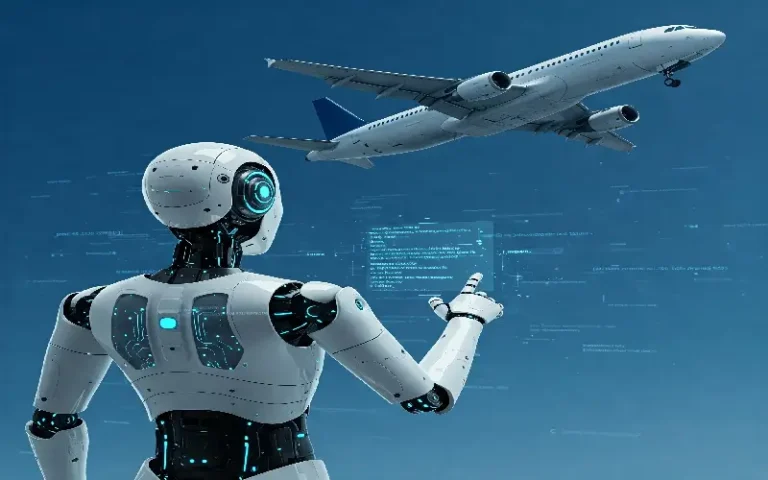





+ There are no comments
Add yours